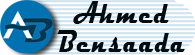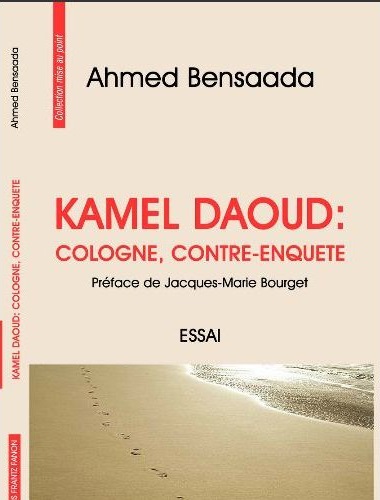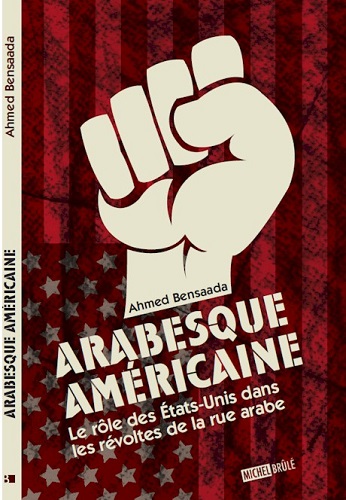بقلم بولس سركو
26-07-2017

الدعاية الإعلامية هي استخدام وسائل الاتصال للتأثير في عقول كتل بشرية كبيرة وعواطفها، وإغرائها وتحويل وجهة تفكيرها وقيمها بما يخدم أهدافاً اقتصادية وسياسية وثقافية وعسكرية لمنظمي تلك الدعاية، الأهداف التي تتنكر بملفات ذات جاذبية خاصة للمتلقي والتي غالباً ما تتعلق بالحقوق المدنية والحريات.
صدر الكثير من الكتب التي بحثت هذه المسألة، ومنها كتاب (المتلاعبون بالعقول) للناقد الأمريكي هيبريت شيلر، وكتاب (من دفع للزمار؟) للكاتبة فرانسيس ستنر سوندرز، وكتاب نعوم تشومسكي (السيطرة على الإعلام– الإنجازات الهائلة للبروباغندا) الذي قدمته المترجمة أميمة عبد اللطيف بأنه يكشف فلسفة وسياسة التحكم في أجهزة الإعلام ومؤسساته، ويعرض لنا التأثير العميق للإعلام وقدرة البروباغندا على خلق ثقافة الرأي العام. ويعطي الكتاب مثالاً عن أول نجاح هائل لعملية دعائية من هذا النوع أثناء إدارة الرئيس ويلسن الذي كان قد انتخب على أساس برنامج بعنوان (سلام دون نصر) في منتصف الحرب العالمية الأولى، وكان المواطنون الأمريكيون مسالمين جداً، وكان على الرئيس مناقضة برنامجه الانتخابي للدخول في الحرب، فشكلت إدارته لجنة (كريل) للدعاية التي نجحت خلال ستة أشهر في تحويل كل المشاعر السلمية إلى احتقان شعبي واسع ضد ألمانيا ورغبة عارمة في تدميرها، وقد قاد هذا النجاح إلى توظيف التكتيك نفسه لإثارة هستيريا شعبية ضد ما سمي بالخطر الشيوعي، وكذلك ضد كل ما هو إسلامي، فيما بعد.
في مقال بعنوان (الأزمة السورية والتضليل الإعلامي) كتب أستاذ مادة الإعلام في جامعة دمشق د. زياد قدور في 3/12/ 2015 إن قوة الإعلام سبقت في السنوات الأخيرة القوتين الاقتصادية والعسكرية، وربط تلك القوة بما نجم عن استخدام الإعلام من تغييرات طالت المعسكر الشرقي، أو ما سمي بالثورات الملونة، وربط كذلك بين تلك (الثورات) وما سمي بالربيع العربي. كما نقل عن الكاتب الكندي من أصل جزائري أحمد بن سعادة كشفه لمهام السفارات الأمريكية العلنية والخفية في كتابه (أرابيسك أمريكي: عن الدور الأمريكي في الثورات العربية) ودورها في التمويل والاتصال المباشر مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والأحزاب الممونعة// الممنوعة؟؟//، ولهذا طلبت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عام 2010 مبلغ 30 مليون دولار للشركات المتخصصة في صنع البرمجيات، لكسر الرقابة ومنع تعقّب تلك المنظمات والنشطاء السوريين المعارضين وتشفير رسائلهم، لإتاحة حرية عملهم في تأجيج مشاعر الغضب الشعبي وإشعال فتيل الانتفاضات.
وأضاف أن الغرب طبق نظرية صراع الحضارات بواسطة عملائه في الداخل والخارج، وأسندت مهمة الحشد الديني وبث الأحقاد والكراهية إلى بعض أئمة المساجد الذين كان يديرهم أفضل خبراء الإعلام وعلم الاجتماع وعلم النفس، وخصصت ساعات طويلة من البث لنشر الفكر التكفيري و(تغيير عقول الشعوب ومواقفها)- على حد تعبير هيلاري كلينتون في إشادتها بجهود قناة الجزيرة القطرية في هذا المجال التي تخطت دور توفير الزخم الإعلامي إلى المشاركة في صنع الأحداث وتوجيه المحتجين في سورية.
كان الإخوان المسلمون أول من بادر لإطلاق الاحتجاجات في سورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالاعتماد على إيقاظ الرواسب الدينية، لتتعالى صيحات التكبير منذ اليوم الأول ولتخفي بريق الشعارات المدنية التي ركبت بالعجز على الواجهة، فلم تصمد لساعات أمام سحر تلك الصيحات ونسبتها الطاغية، فحين خرج في الأيام الأولى لمظاهرات اللاذقية عام 2011 بضعة صبية لا يتجاوز عددهم الخمسة عشر مراهقاً في أحد الأزقة الضيقة والمعتمة من الجانب القديم في حي مار تقلا الذي أسكن في جانبه الأحدث، رددوا بعض الشعارات الملقنة، ولم تستمر المسرحية أكثر من خمس دقائق كانت كافية لكاميرات تصور ثوانيها، لتظهر بعد قليل من الوقت على إحدى القنوات الخليجية كمظاهرات عارمة تجتاح الحي، الأمر الذي استدعى مئات الاتصالات المرتجفة من الخارج بأهالي الحي الذين شاهدوا بأعينهم حقيقة ما جرى، ولم يكن ذلك بالطبع سوى جزء بسيط جداً من مسلسل الفبركة الإعلامية في الحرب النفسية ضد سورية، فحين تطور الوضع في رمضان من العام نفسه إلى حالة هستيرية من الصراخ الجماعي المردد لأوامر الشيخ عدنان العرعور وما تلاه من قرع طناجر، صدمت وأصابني الذهول من حجم التأثير الدعائي على الرأي العام، ولأول مرة في حياتي شعرت بأن العالم قد حاصره الظلام بالكامل.
رغم أن التفاوت الطبقي واختلاف المصالح بين شرائح المجتمع وتراكم الفساد والركود المرعب كان ينذر بعواقب اجتماعية وسياسية وخيمة تلوح في الأفق البعيد، ولكن ما هو غير متوقع على الإطلاق هو القابلية القصوى للتجاوب والتهيّج الجماعي بسبب خطاب إعلامي، واضح في أهدافه الفتنوية وافتعاله وفبركاته ومنحاه الرجعي العام البعيد كلياً عن مفهوم الثورة، بقدر ما كان واضحاً تماماً وقوف الأطراف الخارجية صاحبة المصلحة في خراب البلد وراءه، فشكلت تلك القابلية معبراً شعبياً للأطراف الخارجية إلى الداخل، ومن هنا كانت الخيبة بحجم وطن خرقت حدوده وجغرافيته وقيمه وعلمانيته وتماسكه وأمنه الاجتماعي.
ومع أن اعتماد الدعاية الإعلامية على تلفيق الأحداث والإغواء النفسي، وابتعادها عن الموضوعية والمهنية ومجافاتها للواقع، أسهم في انكشاف كذبة الحياد مع الوقت لدى أعداد متزايدة من الناس، لكن أخطر ما تركته من وجع اجتماعي مزمن هو تشتيتها ذهنية الأفراد وتحويلهم عن اتجاهاتهم وقيمهم وسلوكياتهم، ونجاحها في خرق وعيهم بثقافة تتدفق عدوانية غريزية تجاه الآخر باستمرار، وتنزع للمجابهات الهوياتية الرجعية، فقد أظهرت النقاشات الواسعة التي دارت مع تصاعد الحدث وحتى الآن إلى أي مدى قد أعطبت القيم الإنسانية التقدمية والوطنية التي كانت تتميز بصفات جامعة، ومقدار تراجعها أمام قيم التوحش الأمريكية المفروضة التي ألبست ثوب الحقوق المدنية على حساب الانتماء إلى الوطن، كما أظهرت مدى سطحية التفكير الجديد الذي قلب أسس الصراع وطبيعته في المنطقة، حين يردد طيف واسع من شرائح المجتمع يمتد من بائع الخضروات إلى موظفة المالية إلى صاحب المكتبة إلى طبيبة الأسنان إلى المترجم والروائي والفنان والمثقف النخبوي والتاجر والدكتور الجامعي، ترديداً ببغاوياً، ولا شعورياً، مصطلحات قيم التوحش وعناوينها وحججها، بوهم مفاهيمي مصحوب بنبرة تهكمية جوفاء تجاه كل ما سبق ثقافة ما بعد الحداثة، ونشوة ومباهاة وشحنة معرفية معاصرة زائفة قائمة على التلقين تغيب فيها روح النقد والمساءلة. فلئن كانت فئات من شعبنا قد استوعبت جزئيا الهزة الدعائية الإعلامية الكبرى، فإن المهمة العسيرة، التي ستواجهنا لأمد طويل قادم في إعادة إعمار شخصية الإنسان، هي معالجة ارتدادات تلك الهزة لوضع هذه الشخصية على سكة التقدم مجدداً.
المصدر