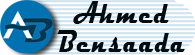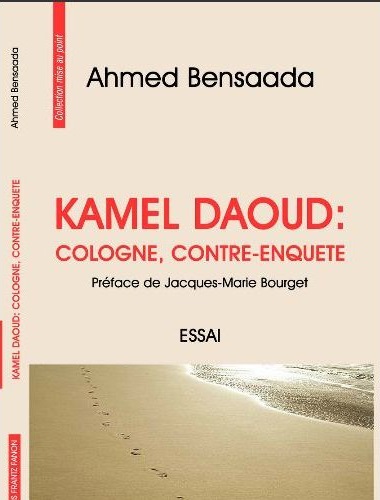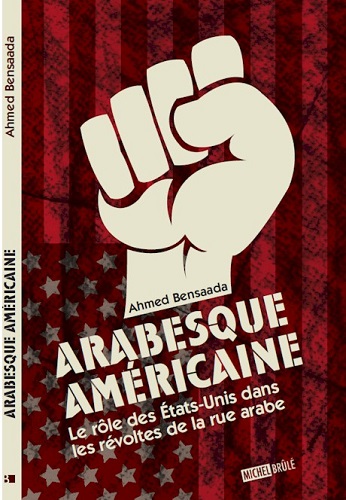يكتب: هاني عبدالله
6 يناير 2016

فى كتابه، الصادر فى مايو من العام 2012م، تحت عنوان: (أرابيسك أمريكية: الدور الأمريكى فى صناعة الثورات العربية - Arabesque Americaine: Role des Etats Unis dans les revoltes de la rue Arabe)، يقول الأكاديمى الكندى – من أصل جزائرى – «أحمد بن سعادة»: إن العشرات من مؤسسات المجتمع المدنى – من دول الشمال الإفريقى إلى بلدان «الشرق الأوسط»، والدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى – قد استفادت من برامج التكوين، والتدريب، و«التأطير»، والتمويل التى ظلت توفرها المؤسسات الأمريكية تحت مسميات وعناوين «مختلفة».. لكنها – أى: تلك البرامج – كانت تلتقي، فى النهاية، حول المضمون نفسه.. إذا كنت تستهدف – إجمالاً – تغيير ملامح خريطة المنطقة.. ومن ثمَّ.. كان أن لعبت السفارات الأمريكية دورًا ميدانيًا كبيرًا فى مختلف الدول العربية «المستهدفة»؛ بعيدًا عن الدور الذى تحدده القوانين، والأعراف الدوليّة (!)
ويتابع: خلال العقدين الماضيين من الزمن، أنفقت (وكالة الأمريكية للتنمية الدولية - (USAID على سبيل المثال: ما لا يقل عن تسعة مليارات دولار من أجل «نشر الديمقراطية الأمريكية فى العالم (!).. علمًا بأن «سلطات واشنطن» صممت هذا البرنامج؛ ليشمل 100 (مائة) دولة.. كما كانت أغلب الأموال المخصصة لتمويل هذه البرامج تأتى من «الكونجرس الأمريكى».. فى حين تتولى وزارة الخارجية الأمريكية توزيعها.
ويلتقط، هنا، «بن سعادة» ملاحظة ذكية للغاية، على هامش ما عُرف بـ«ثورات الربيع العربي»؛ إذ يقول:
لعل ما يدعو إلى الغرابة أن «الأعلام الأمريكية» لم تكن تحرق فى تلك المظاهرات التى اجتاحت المدن والعواصم العربية.. فالمنطق يقول إن المتظاهرين يبادرون بإحراق الأعلام الأمريكية تنديدًا بالدعم الأمريكى لهذه الأنظمة العربية على مدى عقود من الزمن (!)
ويبين «بن سعادة» فى نحو 120 صفحة من الكتاب كيف استطاعت الأجهزة الاستخباراتية بـ«الولايات المتحدة الأمريكية» أن تقود شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة: (تويتر، وفيسبوك، وجوجل) على وجه الخصوص.. إذ إن التعمق فى تحليل الأدوار الخطيرة التى قامت بها هذه «الأدوات التواصلية» على الشبكة العنكبوتية، هو ما مكن «واشنطن» من الركوب على هذه الاضطرابات التى شهدتها الدول العربية حتى تؤثر فى مسارها ولا ترتد عليها، إذ سبق أن لعبت أمريكا الدور نفسه، خلال «الثورات الملونة» التى شهدتها بلدان أوروبا الشرقية (!).. وينبه «بن سعادة» إلى أن عملية «غسل أدمغة» الشباب العربى؛ بدأت منذ العام 2007م بالتركيز على الشباب المستخدم للانترنت؛ إذ إن «بلاد العم سام» استبقت تلك المرحلة بوضع العديد من الاستراتيجيات من أجل إضعاف الأنظمة المستهدفة، والإطاحة بها، وإظهار الأمر – فى النهاية - على أنه نتاج حركة شعبية «داخلية»، تتبنى مطالب «محلية» بحتة (!)
لكن.. ما لم يتطرق إليه «بن سعادة» فى كتابه «المهم» - بشكل تفصيلى- هو أن تلك البرامج «الموجهة استخباراتيًّا»؛ مثلت – فى مجملها – نتاج 50 عامًا من العمل داخل الغرف الأمريكية «المغلقة؛ للتحكم بـ«الثورات»، وتوجيهها وفقًا للمصالح الأمريكية (!).. وهو ما سنقف على تفاصيله، كافة، بالسطور التالية.
(1) بعد 10 سنوات، تقريبًا، من العمل على المشروع؛ بدت بوادر إسقاط وتصعيد الأنظمة «المختلفة» – كاستراتيجية عملت عليها مؤسسات القلب الصلب داخل الولايات المتحدة الأمريكية – تعرف طريقها إلينا، شيئًا فشيئًا.. إذ تكَشّفت بدايات تلك الاستراتيجية عبر مقال «مثير» كتبه (SHELDON S. WOLIN) بالعام 1973م، تحت عنوان: «THE POLITICS OF THE STUDY OF REVOLUTION».
تحدث الرجل عن مشروع «سري» عملت عليه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالعام 1964م.. كان المشروع يحمل اسم: كاميلوت أو «PROJECT CAMELOT»، إذ كان الهدف من المشروع – وفقًا لما تم الكشف عنه إذ ذاك - تعزيز قدرة الجيش الأمريكى على التنبؤ والتأثير فى «التغييرات المجتمعية» بالبلدان الأخرى.. ومن ثمَّ.. فعلى الجيش الأمريكى معرفة آليات تحجيم الثورات وحركات التمرد بالبلدان «الصديقة»، وكيفية صناعة الثورات على الأنظمة «المعادية» أو تلك التى فقدت أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية (!)
خرج المشروع تحت غطاء «بحثى» فى البداية، إذ ضم نخبة من علماء الاجتماع الأمريكيين، وعددًا من الجنسيات الأخرى، تحت إشراف مباشر من «البنتاجون»؛ بهدف تقييم أسباب التمرّد الاجتماعى «العنيف»، والوصول إلى الآليات التى يمكن أن تستخدمها الحكومات الحليفة للولايات المتحدة؛ لمنع سقوطها.. لكن.. بعد مرور الوقت، ترسخ لدى عدد من علماء الاجتماع المشاركين بالمشروع، أن وزارة الدفاع الأمريكية تسعى نحو توظيف نتائج الدراسة فى صناعة «الحركات الثورية» داخل دول أمريكا اللاتينية على وجه التحديد (الخصم المرحلى للولايات المتحدة حينئذ)، وعدد آخر من البلدان بدأت تفقد أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.. وكان على رأس العلماء المتشككين بالنوايا الحقيقية للمشروع؛ عالم الاجتماع النرويجيَ «يوهان جالتونج»، إذ أخذ على عاتقه تحذير باقى المشاركين – خصوصًا «التشيليين» - من أغراض المشروع الحقيقية.
وتدريجيًّا.. وبعد أن تحول الكشف عن المشروع إلى «ثغرة» تم من خلالها توجيه النقد «المكثف» لوزارة الدفاع الأمريكية.. وتحميلها مسئولية «تخريب البحث الاجتماعي»، أعلن «البنتاجون» تخليه عن المشروع؛ حتى لا يصبح عرضة لسهام النقد بأى حال من الأحوال.. لكن.. لم ينته المشروع فعليًّا.. إذ عرفت نتائج البحث كافة طريقها نحو «وكالة الاستخبارات المركزية – CIA»، فى وقت لاحق (!).. فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية، تعلم – يقينًا – أنها أمام تحول جديد فى مفهوم الحروب.. وأن هذا المفهوم (كان هذا المفهوم هو البذرة التى نبت عنها مصطلحا: حروب الجيل الرابع GW4 – وحروب الجيل الخامس GW5 )، يفقد «القواعد العسكرية» شيئًا من أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن.
ففى العام 1963م.. وبعد صعود نجم حركات التحرر فى فيتنام، والكونغو.. والثورات فى كوبا، واليمن.. وجدت الولايات المتحدة أنها تفقد دورها أمام معارك مسلحة «بدائية» على خلاف «الحروب المنظمة».. ومن ثمَّ.. كان لابد من ايجاد بديل عن الوسائل التقليدية؛ لاستعادة السيطرة.
(2) كان هذا الأمر – وقتئذ - من مهام وكالة الأبحاث العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إذ اعتبر عدد من خبراء الوكالة أن العلوم الاجتماعية قد تكون، هى «البديل المحتمل» مستقبلاً.. وعلى هذا.. تم تصميم مشروع دراسات اجتماعية لدول العالم النامى (كاميلوت)؛ بهدف التنبؤ بالثورات، وحركات التمرد.. فضلاً عن أسبابها فى بلدان العالم الثالث، والعمل على ايجاد الوسائل المناسبة للقضاء على مسبباتها، أو التأقلم السريع معها.
مول المشروع من قبل الجيش الأمريكى، خلال 4 سنوات بنحو (6 ملايين دولار)، بالتعاون مع منظمة أبحاث العمليات الخاصة، التابعة اسميًّا لجامعة واشنطن (إحدى الأذرع العلمية للجيش الأمريكى)، إذ ركزت تلك السنوات الأربع على دول أمريكا اللاتينية، إلى جانب عدد آخر من البلدان الأوروبية، والآسيوية، والإفريقية، منها: (مصر، وإيران، وتركيا، وفرنسا، واليونان).
وقتئذ.. تم إرسال طلبات التعاون لعدد من الباحثين؛ تأسيسًا على أن المشروع يستهدف إيجاد وسائل للتنبؤ بمجريات التغيير الاجتماعى فى البلدان النامية، والقدرة على التأثير بتلك التغييرات سياسيا؛ عبر تطوير أدوات تقييم احتمال وقوع «نزاعات داخلية»، وتحديد الاجراءات التى يتوجب على الدولة القيام بها؛ لتقليص احتمالية نشوب نزاعات أهلية (!).. وكان من بين ما أكدت عليه تلك الرسائل: أهمية دور الجيش الأمريكى، ومسئوليته فى بناء الدول النامية، ومساعدة هذه الدول على التعامل مع حركات التمرد الداخلى بشكل وقائى (!)
وحتى تكتمل الشبكة الأمريكية؛ لاختراق البلدان المستهدفة.. تم اسناد مهمة إدارة المشروع لـ«بروفيسور فى علم الاجتماع» من جامعة بروكلين متخصص فى دراسة الثورات بأمريكا اللاتينية، إذ وجد هذا البروفيسور فى المشروع فرصة «مغرية»؛ لتمويل أبحاثه.
كما تواصل باحث أمريكى آخر من «أصول تشيلية» بشكل «غير رسمى» مع عدد من الأكاديميين فى تشيلى ؛ لتنفيذ المشروع هناك.. وتم الاتصال بباحث نرويجى متخصص فى النزاعات بأمريكا اللاتينية؛ من أجل الانضمام لفريق العمل.. لكنه رفض لأسباب متعددة، منها: تشككه بمصدر تمويل المشروع (البنتاجون)، إذ اعتبر أن حديث الجيش الأمريكى عن «دوره التنموى» أمر مشبوه.. فى ظل الصراعات التى تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، أو تلك التى تسبب فى وجودها من حيث الأصل (!)
لكن.. بعد أن خرجت تفاصيل المشروع للعلن، وتراجع «البنتاجون» عن الاستمرار فى تنفيذه.. كانت الأفكار التى تمت بلورتها داخل «كاميلوت» تتجه مباشرة نحو جانب آخر من جوانب «القلب الصلب الأمريكى»، مع اختلاف المسميات.. ونقصد بذلك وكالة الاستخبارات المركزية (CIA).
(3) فى النصف الأخير من الستينيات.. وبالتزامن مع تنفيذ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لمشروع «كاميلوت»، خلال الفترة التى تولى خلالها «ليندون جونسون» رئاسة الولايات المتحدة.. كانت «وكالة الاستخبارات المركزية – CIA» مستغرقة حتى أذنيها، فى العديد من العمليات القذرة (DIRTY MISSIONS) داخل الكثير من بلدان العالم؛ ابتداءً من أمريكا اللاتينية، وحتى الصين.
ففى أعقاب انتهاء ولاية جونسون رسميًّا (20 يناير 1969م).. كان أن خلفه فى موقعه «ريتشارد نيكسون».. ومن ثمَّ؛ طلب «نيكسون» من مدير وكالة الاستخبارات المركزية تقريرًا تفصيليًّا عن العمليات التى تديرها الوكالة فى الخارج.
ذهب «هيلمس» – مدير الوكالة – للمكتب البيضاوى، بصحبة مستشار الأمن القومى «هنرى كيسنجر» فى 25 مارس من العام 1970م؛ لدراسة الأمر.. وفى الأسبوع التالي.. أرسل مذكرة «خاصة» بما يتعلق بعمل الوكالة فى: كوبا، وكمبوديا، ولاوس، وغيرها من البلدان.. وكيف أصبح كل من: «راديو أوروبا الحرة»، و«راديو ليبيرتي» يؤثران على نحو 30 مليون شخص فى أوروبا الشرقية، ويفسدان تحركات «الاتحاد السوفيتي» بالمنطقة.. مما دفع الأخير لانفاق نحو 150 مليون دولار «سنويًّا»؛ للتشويش على عمليات البث تلك.
لكن.. لم يستوقف «نيكسون» سوى فقرة وحيدة من بين ما ذكرته المذكرة، إذ جاء بها: (هناك حالات كثيرة قمنا بها، فى ظل التهديد بفوز الحزب الشيوعي، أو الجبهة الشعبية فى الانتخابات بالعالم الحر.. وتمكنا من تحويل التهديد إلى نجاح؛ باسقاط كتل اليسار.. وما حدث فى «جويانا» – إحدى دول الساحل الشمالى بأمريكا الجنوبية – فى العام 1963م، و«تشيلي» فى العام 1964م، خير دليل على هذا النجاح.. فنحن مستعدون للعمل بموجب «برامج انتخاب خفيّة» مخطط لها بعناية)، إذ راقت تلك اللعبة لـ«نيكسون» إلى حد بعيد (!)
كما قامت الوكالة بانفاق نحو 65 مليون دولار؛ لشراء النفوذ فى «روما، وميلانو، ونابولي»، فضلاً عن تقديمها دعمًا «سريًا» لعدد من السياسيين فى أوروبا الغربية، أثناء المرحلة الأولى من الحرب الباردة.. وتضمنت القائمة – وفقًا لـ «تيم واينر» فى كتاب «إرث من الرماد» – المستشار الألمانى «ويلى براندت»، ورئيس الوزراء الفرنسى «جى موللي»، وكل ديمقراطى مسيحى فاز بالانتخابات العامة فى إيطاليا (!)
وكانت هذه بمثابة نقطة انطلاق جديدة لكل من: نيكسون، وكيسنجر؛ إذ قررا إحياء تلك الممارسات لتغيير الأنظمة بعيدًا عن التدخل العسكرى المباشر، عبر استقطاب الشخصيات العامة فى البلدان المستهدفة، وتقديم الرشاوى المالية.
ففى خلال تلك الفترة.. كانت الوكالة تشرف – أيضًا – على عدد من العمليات العسكرية المباشرة داخل آسيا.. وحسبما أوضحت برقية تالية، فإن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تحتفظ بقوة عسكرية خفية «غير نظامية» قوامها 39 ألف مقاتل فى فيتنام، منذ العام 1960م.. وأن هؤلاء المقاتلين (الهمونج)، ممن يقودهم الجنرال «فانج باو»، تحملوا قسطا كبيرًا من المواجهات ضد الشيوعيين.. فوجه «نيكسون» وكالة الاستخبارات المركزية بإنشاء كتيبة جديدة من شبه العسكريين «التايلانديين» فى لاوس.
(4) بينما كانت تستعر مواجهات الفرق العسكرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية على الأرض فى جنوب شرق آسيا.. وضع نيكسون، وكيسنجر خططهما؛ للتقارب «سرًّا» مع الحزب الشيوعى الصينى (!).. ولفتح الطريق إلى الصين، قاما بتقويض عمليات الوكالة ضد النظام الشيوعى «نسبيًّا».. وكان الهدف؛ هو اختراق الكتل الشيوعية المختلفة من الداخل، عبر الاعتماد بصورة أكبر على مقومات حروب «الجيل الرابع».. ومن ثمَّ.. تراجعت – نوعًا ما – عمليات فرق «الكوماندوز» فى الحرب الكورية، فى مقابل زيادة عمليات البث الإذاعية «الموجهة» من: «تايبيه»، وسيول.. فضلاً عن منشورات تم إسقاطها على البر، وأخبار كاذبة تزرع فى «هونج كونج»، وطوكيو؛ لتشويه سمعة «جمهورية الصين الشعبية».
وفيما كانت الوكالة تواصل دعمها - بشكل دؤوب – للمتمردين فى «هضبة التبت»، وحركة تحرير تايوان.. كان «كيسنجر» على موعد مع رئيس وزراء بكين «شو إن – لاي».. وحينها دار الحوار التالى:
شو: أليست «المخابرات الأمريكية» وراء العمليات العسكرية الأخيرة فى تايوان؟
كيسنجر: أنت تبالغ فى تقدير دور وكالة الاستخبارات المركزية كثيرًا.
شو: لقد أصبحت الوكالة موضوعًا للمناقشة فى أغلب أنحاء العالم!
كيسنجر: هذا صحيح.. وهذا يجعلهم ينظرون لأنفسهم بعجب لا يستحقونه!
شو: لكن الوكالة لا تزال تعمل على تخريب الجمهورية الشعبية، بكل الطرق!
كيسنجر: معظم ضباط «سي. آي. أيه» يكتبون تقارير مطولة وغير مفهومة!.. لكنهم يعجزون عن (صنع الثورات)!
شو: أنت تتحدث الآن عن «ثورات».. لكننى أحدثك عن أعمال تخريب!
كيسنجر: نعم تخريب.. أتفهم هذا!.. نحن ندرك تمامًا ما هو على المحك فى علاقتنا، ولن نسمح لمنظمة واحدة بالقيام بعمليات طفيفة يمكنها أن تعترض هذا المسار. وكانت تلك هى نقطة نهاية الجملة «بشكل مرحلى» فى عمليات الوكالة داخل الصين.. لكن.. بحلول العام 1970م، كانت أيادى الوكالة تمتد إلى الصراعات المختلفة داخل نصف الكرة الأرضية تقريبًا.. بما فى ذلك «أعمال التجسس» على المواطنين الأمريكيين أنفسهم (!).. وهى الفضيحة التى عرفت إعلاميًّا بـ(ووتر جيت)، وكتبت نهاية إدارة نيكسون داخل البيت الأبيض، بشكل تراجيدى.
لكن.. كان لهذه «الفضيحة» أثرها «الفعال» فى تغيير آليات عمل الوكالة – (نقصد: سي. آي. إيه) – وخروجها من نطاق السرية إلى نطاق «العلانية».. عبر تصدير ما عُرف ببرامج (نشر الديمقراطية)؛ لاستكمال الدور الذى كانت تلعبه «وكالة الاستخبارات المركزية» سرًّا، فى تغيير نظم الحكم (!) .. وهو ما سنقف على تفاصيله – بشكل كامل - الأسبوع المقبل.
المصدر:
نشر هذا المقال أيضاً على:
 |